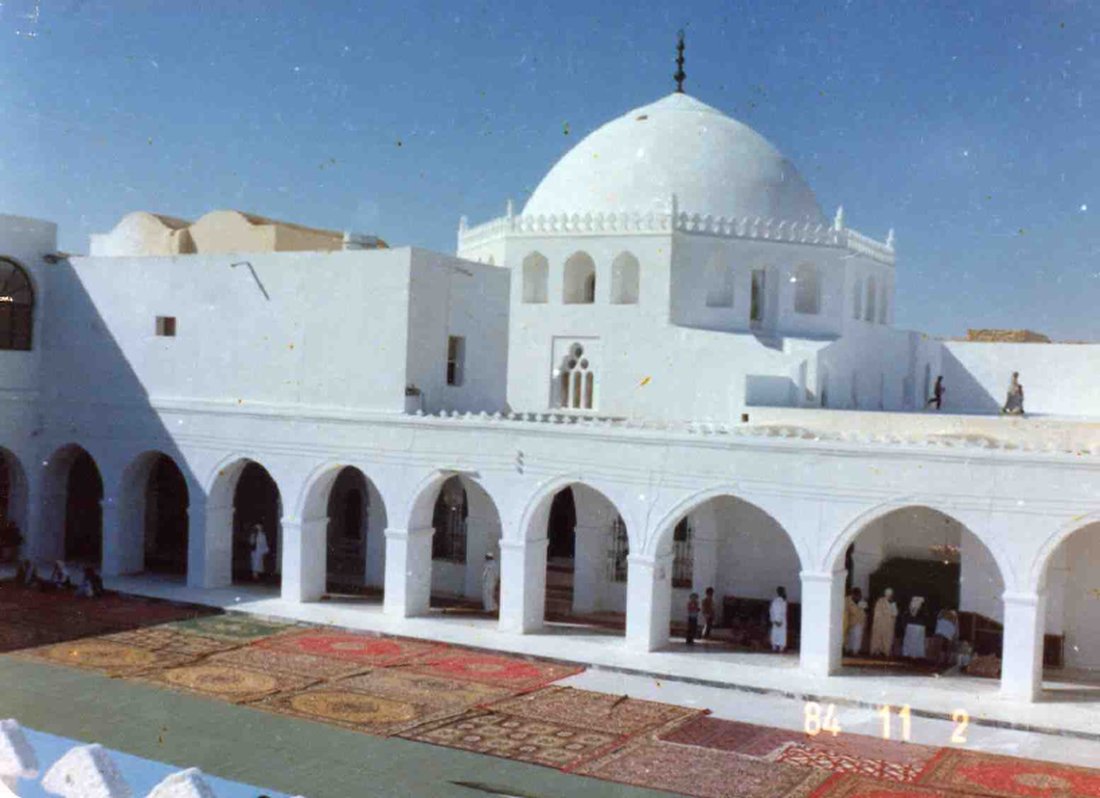الدكتور رفيق عبد السلام
 ملخّص:
ملخّص:
ظلت مقولة خطر الإسلاميين على الديمقراطية عقودا متتالية، تتردّد على المسامع والأبصار، وتحبّر بشأنها المقالات والنصوص، حتى غدت أشبه ما تكون بمسلّمة ثابتة لا تقبل المساءلة أو الدحض. وإن الديمقراطية، في تقديري، ليست أيديولوجيا كبرى، ولا هي دين في مواجهة الأديان، بل هي نظام سياسي يوفر آلياتٍ وضماناتٍ تصلح لتنظيم الشأن السياسي وعقلنته.
وقد زادتني أحداث الربيع العربي قناعةً بهذه المقاربة البراغماتية للديمقراطية، على الرغم من الرفض الذي يلقاه هذا الطرح من الليبراليين ممن يميلون إلى تحويل الديمقراطية إلى ما يشبه العقيدة الكلية، إما أن تؤخذ كلها أو تردّ كلها. بيد أنه تجب الإضافة هنا، من وحي التجربة العملية، أن الديمقراطية الإجرائية لا يمكن أن تشتغل إلا ضمن ما يمكن تسميتها ترتيبات “ما قبل ديمقراطية” هي بمثابة الشروط المؤسّسة والضامنة للعملية الديمقراطية.
مقدّمة:
يرى المناوئون لأطروحات الإسلاميين في الديمقراطية أنها لا تعدو عندهم سوى جسر عبور باتجاه الاستحواذ على الحكم وقطع الطريق أمام أي منافسةٍ محتملة، ومبعث ذلك يعود إلى أن أدبياتهم السياسية تتناقض في الصميم مع أسس النظام الديمقراطي، فهم ينادون بالحاكمية الإلهية مقابل سيادة البشر، وسلطان الشريعة المتعالية مقابل سلطة الشعب في هذا العالم (المحايث). وفي سياق تأكيد صحة هذه القراءة، غالباً ما تُستدعى نماذج من الجماعات الإسلامية العنيفة من تنظيم القاعدة وأمثاله، واستحضار بعض شعاراتها المخيفة، للتدليل على صحة هذه القراءة.
الإسلاميون والديمقراطية
للإسلاميين مشكلاتهم الفكرية والسياسية، ولديهم ما يستوجب النقد والتصويب، إن على صعيد خطابهم أو تجربتهم السياسية، على نحو ما ذكر الكاتب في مقال سابق. ولكن هذا لا ينفي وجود تجاهل متعمّد للمسافات التي قطعها الإسلاميون المعتدلون في “شرعنة الديمقراطية” في الساحة الإسلامية، وتخطي فكر الجماعات السلفية الرافضة لها، لمصلحة ما بات يعرف بالتأصيل الإسلامي للديمقراطية.
دوّن راشد الغنوشي منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، وهو في سجون بورقيبة، كتابه “الحريات العامة في الدولة الإسلامية” (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1993). ونظّر محفوظ نحناح في الجزائر لما أسماها الشوروقراطية، قاصداً بذلك الالتقاء بين تقاليد الشورى الإسلامية والفكرة الديمقراطية. وكتب حسن الترابي في السودان في قضايا الحرية والدستور والإرادة الشعبية، على الرغم من أن أفكاره السياسية لم تترجم في التجربة السياسية التي قادها في موطنه السودان. نشر يوسف القرضاوي وطارق البشري وفهمي هويدي، ومن قبلهم توفيق الشاوي، أطروحاتهم في “تأصيل” الحرية والدستور والديمقراطية، مع الحمْل على النظام الاستبدادي والحكم المطلق.
والحقيقة أنه لم ينقضِ القرن الماضي حتى استقرّت الفكرة الديمقراطية في الوسط السياسي الإسلامي الرئيسي، بل انتهت التيارات الإسلامية الرئيسية إلى انتهاج آلية الانتخاب في إفراز قياداتها وإدارة مؤسّساتها بشكل يتفوق على نظرائها من الأحزاب اليسارية والليبرالية، على الرغم من وجود خطوط ضغط شديدة على يمين الإسلاميين من مجموعات سلفية مدعومة سعودياً، تسفّه التوجهات الديمقراطية، وتدافع عن إسلام تيوقراطي، يقوم على معاني الطاعة المطلقة لولي الأمر.
إن مشكلة الإسلاميين لا تتعلق بمدى قبولهم بالخيار الديمقراطي، فهذه أصبحت حقيقة معلومةً، والتشكيك فيها أقرب ما يكون إلى اللغو السياسي، بقدر ما أن مشكلتهم تعود إلى غلبة الطابع السجالي والنظري لمفهوم الديمقراطية في خطابهم، بما صرف أنظارهم عن المعطيات الموضوعية على الأرض، بكل تلاوينها وتعقيداتها.
ظل الإسلاميون يشغلون أنفسهم بهاجس التأصيل والنبش في النصوص الشرعية والفقهية والشواهد التاريخية لتأسيس مشروعية الديمقراطية في الإسلام، أكثر من البحث عن الشروط التاريخية والسياسية التي تجعل من الديمقراطية أمراً ممكناً، أي تشخيص موانعها ومعوّقاتها في هذه الرقعة من العالم الموبوءة بداء الاستبداد والحكم الفردي. كيف ذلك؟ سقط الإسلاميون من الحكم، أو بالأحرى أسقطوا، لا لأنهم كانوا غير ديمقراطيين، بل الأرجح لأنهم كانوا ديمقراطيين بصورة زائدة على اللزوم في مناخٍ غير ديمقراطي، يتسم بكثرة الصراعات والمؤامرات والتدخلات الخارجية.
وبهذا المعنى، يمكن القول إنهم كانوا ضحايا سرديّتهم الديمقراطية على النحو الذي نظّروا له طول العقود الثلاثة الأخيرة على الأقل. تمسكوا بمثاليات الديمقراطية ومقولات التداول والأغلبية والأقلية والانتخابات في وضعٍ مشحونٍ بالتوترات والصراعات، ويطغى عليه تحكّم الجيوش وأجهزة الأمن، وتوظيف المال والإعلام وتدخل النفوذ الإقليمي ضدهم.
في مصر، تعامل الإسلاميون بخلفية الشرعية الانتخابية وثنائية الأقلية والأغلبية، كأنهم يعيشون في نظامٍ ديمقراطيٍّ مستقر على طريقة جنيف أو وستمنستر، فلم يأخذوا بالاعتبار موازين القوى السياسية على الأرض، وكيفية بناء التحالفات السياسية، وطبيعة التهديدات الداخلية والخارجية المتأتّية من قوى غير ديمقراطية محيطة بهم، داخلياً وخارجياً.
وفي تونس انتبه الإسلاميون النهضويون إلى أهمية التوافق والمساومات السياسية في إدارة وضع ديمقراطي ناشئ، وتحسّسوا بقدر من الواقعية طبيعة الأرض التي يقفون عليها، ولكنهم كانوا، هم الآخرون، بالغي التسامح والارتخاء في التعامل مع قوى غير ديمقراطية، كانت تتربّص بهم، وبالتجربة الديمقراطية، شرّاً، فقد تسللت القوى الفوضوية والتوجهات الشعبوية من داخل النظام الديمقراطي، بخلفية تخريب العملية الديمقراطية والانقضاض عليها، من دون أن تجد حواجز أو مقاومة قانونية أو مؤسّساتية تذكر.
وهنا، لا يُلام الإسلاميون على تهديدهم أسس الديمقراطية بقدر ما يُلامون على كثرة تردّدهم وتراخيهم في التعامل مع المهدّدات المحيطة بهم، فقد تركوا خصومهم المسلحين بالإعلام والمال والإسناد الإقليمي ينسجون حبال المشانق حول رقابهم، من دون قوة ردع ديمقراطي.
محور الاستبداد العربي: نحو إعادة تشكيل المشهد
الدرس المستخلص من ذلك كله، أن على من يتقدّم إلى موقع الحكم، ولو عبر صناديق الاقتراع في مثل هذه الأوضاع بالغة التقلّب، إدراك أنه دخل على خط النار وحلقة الاستهداف المركز. ولذلك لا ينفع التوقف في منتصف الطريق، والتذرّع بعدم امتلاك أدوات السلطة، لأن الحكم لا يحتمل المناطق الوسطى، فإما أن تحكُم وتتحمّل تبعات ذلك من أعباء ومخاطر، وإما أن تبتعد، من البداية، عن مساحة الاحتكاك، وتبقى في المعارضة أو ضمن العمل الإصلاحي العام.
من هنا، تتأتى الحاجة لصياغة نظريةٍ، أو بالأحرى نظريات في التحوّل الديمقراطي، مستمدة من تربة المنطقة وخصوصيات أوضاعها. لا غرو أن جل أدبيات “الانتقال الديمقراطي” التي تدرّس في الجامعات وأقسام العلوم السياسية استنبط أكثرها من وحي تجارب التحوّل في أميركا الجنوبية ودول جنوب أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ولا تصلُح سنداً أو مرجعاً في تشخيص مشكلات التحوّل السياسي أو حاجات منطقتنا.
إحدى الحلقات المغيبة في هذه الأدبيات دور المعطى الإقليمي المختلط برائحة النفط في تخريب التجارب الديمقراطية الناشئة في العالم العربي، ففي ظل حالة الفراغ السياسي الحاصل في المنطقة، نتيجة الإنهاك الذي أصاب الولايات المتحدة بعد تدخلاتها العسكرية المشطّة والفاشلة، ثم تركيز جهودها أكثر على مواجهة الخطر الصيني، تحرّك محور الاستبداد العربي بكل عدوانيةٍ وشراسةٍ لإعادة تشكيل المشهد، والإجهاز على تجارب الربيع العربي، واحدة بعد الأخرى.
كان هناك شعور متنامٍ لدى هذا المحور بأن أميركا أوباما قد مارست في حقه “غدراً ديمقراطياً” حينما تركت بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر يواجهان مصيرهما في مواجهة قومةٍ شعبيةٍ، من دون أن تحرّك ساكناً. ولذلك صمم هذا المحور على أن يتقدّم وينزع “الشوك الديمقراطي” بنفسه، من طريق ضخّ المال وتوجيه الإعلام، وتغذية الحنين للأنظمة السابقة، مع إثارة كل خطوط الصراع والتناقضات الداخلية لتقويض فرص التحوّل الديمقراطي في المنطقة.
كنت قد ذكرت، منذ سنة 2003، في كتابي “في العلمانية والدين والديمقراطية”، أن الديمقراطية ليست أيديولوجيا كبرى، ولا هي دين في مواجهة الأديان، بل هي نظام سياسي يوفر آلياتٍ وضماناتٍ تصلح لتنظيم الشأن السياسي وعقلنته. وقد زادتني أحداث الربيع العربي قناعةً بهذه المقاربة البراغماتية للديمقراطية، على الرغم من الرفض الذي يلقاه هذا الطرح من الليبراليين ممن يميلون إلى تحويل الديمقراطية إلى ما يشبه العقيدة الكلية، إما أن تؤخذ كلها أو تردّ كلها. بيد أنه تجب الإضافة هنا، من وحي التجربة العملية، أن الديمقراطية الإجرائية لا يمكن أن تشتغل إلا ضمن ما يمكن تسميتها ترتيبات “ما قبل ديمقراطية” هي بمثابة الشروط المؤسّسة والضامنة للعملية الديمقراطية. كيف ذلك؟
رهانات الديمقراطية في الواقع العربي الجديد
الواضح عندي أن النظام الديمقراطي لا يمكنه الصمود من دون وجود ضمانتين أساسيتين: أولاً، بناء توافق موسّع بين النخب حول الحد الأدنى الديمقراطي المطلوب، بعيداً عن المعادلة الصفرية التي تجعل الخاسرين يميلون إلى الأساليب التخريبية والانتحارية، بحيث يتم القبول بقواعد اللعبة في حال النصر أو الهزيمة في إطارٍ يحفظ مصالح الأقلية والأغلبية على السواء. ثانياً، الصرامة في تطبيق الآليات الديمقراطية وضمان احترامها والخضوع لها من الجميع، وهذا يقتضي فرض علوية القانون والصرامة في تطبيقه على الجميع، ومن ذلك تثبيت مهنية الإعلام واستقلالية القضاء، وإبعاد الجيش عن التدخل في الحياة السياسية وتحييد الأجهزة الأمنية.
ومن دون ذلك كله، تبقى الديمقراطية مجرّد رغبة في صدور المدافعين عنها، أو مناورة لإعادة تموقع القوى الاستبدادية. لا يمكن الديمقراطية أن تستمر في أجواء التحريض الإعلامي وحالة الفوضى وتعطيل المؤسسات التي تعمد إليها قوى غير ديمقراطية، تستغل صعوبات التحوّل ومناخات الحرية التي وفرها لها النظام الديمقراطي، للانقضاض عليه وتخريبه من الداخل.
خاتمة:
إن الديمقراطية، على النحو الذي بيّنّا، تتحول إلى حالة من الفوضى والوهن المؤسساتي، إن لم تكن لها مخالب وأنياب لتحصين نفسها وردع خصومها، بما يمهد لانهيارها في أي منعطف من المنعطفات التي تواجهها، أو لأن تُستخدم مجرد مطيّة لتخلُق ديكتاتورية جديدة في أحشائها، بوجه عسكري أو مدني، على نحو ما جرى في مصر وليبيا وتونس وغيرها من تجارب الربيع العربي.
ويعيدنا هذا الأمر إلى معطى الصراع، أو بالأحرى مقولة الحرب الصامتة أو المعلنة في الحقل السياسي، التي يؤكدها كارل شميت، بعيداً عن نظريات الليبراليين التي تصوّر الشأن السياسي بمثابة عملية تجري في عالم معقلن، يقوم على التعاقد الحر بين مواطنين أحرار، وهو أشبه ما يكون بعالم ملائكة مسالمة وموادعة لا علاقة له بالواقع، خصوصاً واقع العالم العربي المسكون بروح التوحش.
بيّنت التجربة العملية أن الديمقراطية هي رهان مرهق ومكلف في العالم العربي، ودونه رقاب ودماء وتضحيات، وهي ليست نزهة قصيرة وممتعة، بل هي أشبه ما يكون بمن يلاعب ثعابين الصحاري الشرسة.
_______________