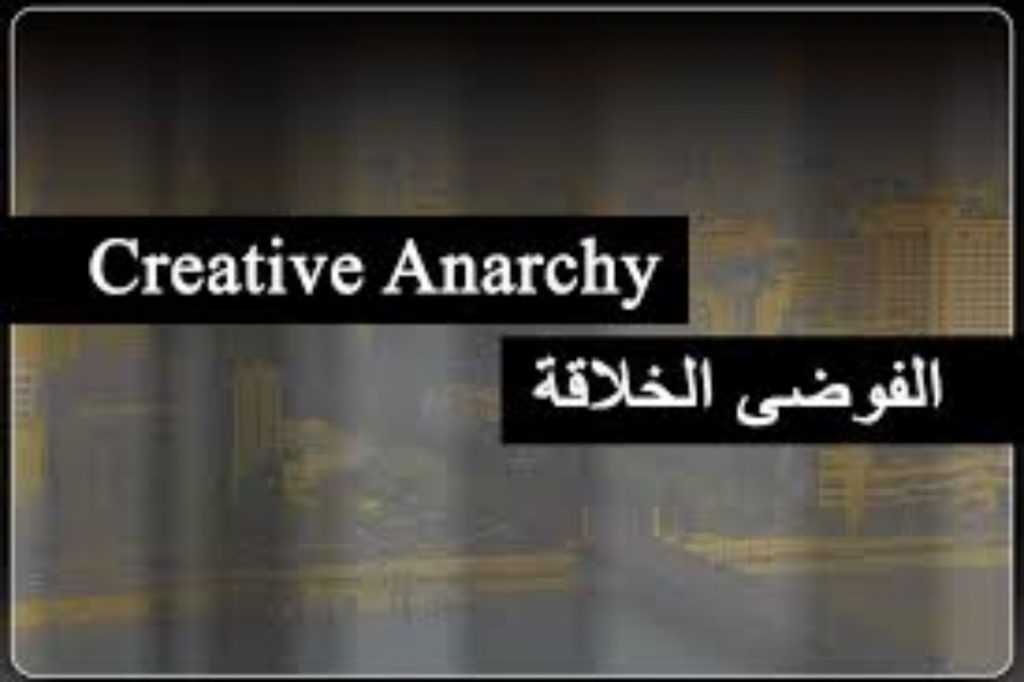فرج أبوخروبة
 لم تعد الفوضى في ليبيا مجرد حالة سياسية عابرة، بل تحوّلت إلى بنيةٍ ذهنية واجتماعية متجذّرة، تفرض حضورها على تفاصيل الحياة اليومية، وتعيد تشكيل علاقة المواطن بوطنه ومصيره.
لم تعد الفوضى في ليبيا مجرد حالة سياسية عابرة، بل تحوّلت إلى بنيةٍ ذهنية واجتماعية متجذّرة، تفرض حضورها على تفاصيل الحياة اليومية، وتعيد تشكيل علاقة المواطن بوطنه ومصيره.
فحين تغيب الدولة، لا يغيب النظام فقط، بل تغيب المعاني الكبرى: فكرة القانون، وهيبة المؤسسات، وإحساس الناس بالانتماء.
ليبيا التي كانت يومًا مسرحًا لحلمٍ جماعي بالتحرّر والعدالة، باتت اليوم سؤالًا مؤجلًا حول معنى الدولة، وحدود المسؤولية، وإمكانية النهوض من الركام.
منذ عام 2011، حين انهار النظام السابق بكل ما له وما عليه، لم تنجح ليبيا في أن تؤسس لنظامٍ بديلٍ متماسك.
سقطت البنية الصلبة للدولة القديمة، دون أن تُزرع مكانها مؤسسات جديدة تملك الشرعية والكفاءة معًا.
كان سقوط النظام أشبه بانفجارٍ لم يترك سوى الفراغ، وفي ذلك الفراغ تخلقت أشكالٌ متضاربة من السلطة، وتكاثرت القوى والمليشيات، وتنازعت المدن والقبائل والمناطق على الشرعية والتمثيل.
لم تكن الثورة الليبية خطأ، ولكنّ خطأها الأكبر كان في سوء إدارة ما بعدها؛ حين استُبدلت الدولة بالمجموعات، والمشروع الوطني بالمشروعات الجزئية، والهمّ الجمعي بحساباتٍ ضيقة تحكمها المصالح والولاءات.
ولم تكن النخب السياسية التي تصدّرت المشهد بعد الثورة أفضل حالًا من الواقع الذي ورثته. ففي الوقت الذي كانت فيه البلاد بحاجةٍ إلى حكمةٍ تاريخية تُعيد بناء التوافق الوطني، انشغلت تلك النخب بحسابات السلطة والشرعية والمغانم.
تقاسموا المناصب قبل أن يتقاسموا المسؤولية، وراح كلّ طرفٍ يدّعي امتلاك الحقيقة واحتكار الوطنية، حتى صار الوطن نفسه ميدانًا للصراع لا غاية له. تتبدّل الحكومات، وتتعدد البرلمانات، وتُعقد المؤتمرات، ولكن الأزمة تبقى هي نفسها، لأن المرض الحقيقي لم يُعالج بعد: غياب الرؤية الجامعة.
فالسياسة التي تُمارس بلا مشروعٍ وطني تتحول إلى عبءٍ على الدولة، والسياسي الذي لا يرى أبعد من مقعده لا يصنع تاريخًا بل يستهلكه.
ثم جاء الخارج، كعادته، حين شمّ في الانقسام الداخلي فرصة للنفوذ والهيمنة. لم تعد ليبيا منذ 2011 سيدة قرارها، بل تحولت إلى رقعةٍ مفتوحة على صراعاتٍ دولية وإقليمية متشابكة.
كلّ دولةٍ جاءت تحمل شعار «دعم الاستقرار»، لكنها في الحقيقة كانت تبحث عن نصيبها من الكعكة الليبية: نفط، موقع، أو نفوذ.
بعضهم دعم هذا المعسكر، وآخرون دعموا المعسكر المقابل، والنتيجة واحدة: تعميق الجرح، وتأبيد الفوضى. أما المجتمع الدولي، الذي تدخّل عسكريًا لإسقاط النظام، فقد انسحب بعد ذلك تاركًا البلاد تواجه مصيرها وحدها، كمن يهدم بيتًا على وعدٍ بإعادة بنائه، ثم يمضي دون عودة. ب
ذلك تحولت ليبيا من «قضية داخلية» إلى «ملفٍ إقليمي»، ومن «دولة ذات سيادة» إلى «مساحة تنازع مصالح»، ومن «شعبٍ يبحث عن مستقبله» إلى «ورقة تفاوضٍ على طاولة الآخرين».
وسط هذا الصخب، يقف المواطن الليبي متعبًا، محاصرًا بين فقدان الأمان وانعدام الأفق. ينام على وعود الإصلاح ويستيقظ على أخبار الانقسام، يرى ثروات بلاده تُهدر في صراعاتٍ عبثية بينما يزداد فقرًا وعزلة.
تراجعت الخدمات الأساسية حتى صار انقطاع الكهرباء حدثًا معتادًا، وانهيار الصحة والتعليم أمرًا مألوفًا. لكن ما هو أخطر من كل ذلك أن الفوضى نجحت في إعادة تشكيل وعي الناس، فصار الخوف هو اللغة اليومية، واللامبالاة هي رد الفعل العام.
عندما يتكرّر الألم بلا جدوى، يتحوّل إلى عادة، وعندما تطول الأزمة، يعتادها المجتمع كما يعتاد الطقس القاسي. وهنا يكمن الخطر الأكبر: أن تتطبع الفوضى في الوجدان، فيغدو الاستقرار نفسه حدثًا غريبًا يحتاج إلى تبرير.
ليست المسؤولية هنا شأنًا أحاديًا أو اتهامًا لطرف دون آخر. إنها مسؤولية الجميع، بدرجاتٍ متفاوتة، لكنها تتقاطع عند نقطةٍ واحدة: غياب الشعور بالمسؤولية الوطنية الجامعة.
الطبقة السياسية تتحمّل نصيب الأسد، لأنها فشلت في تقديم نموذجٍ وطنيٍ يُعلي مصلحة الدولة فوق كل اعتبار. والقوى الإقليمية تتحمل ذنب استغلال هشاشة ليبيا لمصالحها الخاصة.
والمجتمع الدولي مسؤول عن تخلّيه المبكر وازدواجية مواقفه. أما المواطن الليبي نفسه، فهو يتحمّل جزءًا من المسؤولية حين يصمت طويلاً أو يرضى بالقليل، وحين يستسلم للانقسام كأنه قدر لا يُرد.
لا خلاص من دون اعترافٍ صريح من الجميع بأن الطريق الذي سلكوه كان خاطئًا، وأن العودة إلى الدولة هي السبيل الوحيد لإنقاذ ما تبقّى من الوطن.
إن ليبيا اليوم تقف عند مفترقٍ حاسم: إمّا أن تُعيد بناء نفسها على أسسٍ جديدة من التوافق والسيادة والعدالة، وإمّا أن تستسلم لدوامة الفوضى حتى تفقد شكلها وذاكرتها.
المصالحة الوطنية ليست ترفًا سياسيًا، بل ضرورة وجودية، لأن البديل عنها هو الفناء البطيء. والعدالة الانتقالية ليست انتقامًا من الماضي، بل جسرٌ نحو المستقبل.
لا يمكن بناء دولة بينما يتقاسمها سلاحان وخطّان أحمران ومصرفان مركزيان. ولا يمكن أن يتأسس وطن على عقلية «الغالب والمغلوب»، لأن الوطن، في النهاية، لا ينتصر إلا إذا انتصر الجميع معًا.
إن أعظم إنجاز يمكن لليبيين أن يحقّقوه اليوم ليس في توحيد الحكومات ولا في تنظيم الانتخابات فحسب، بل في استعادة الإيمان بفكرة الدولة نفسها.
وربما آن الأوان لأن يدرك الجميع أن الوطن لا يُبنى بالبيانات ولا بالمؤتمرات، بل بالفعل الصادق، وبالإرادة التي تنبع من الداخل لا من الخارج.
لا يمكن لأي اتفاقٍ دولي أن يصنع لليبيين سلامًا إن لم يكن السلام خيارهم هم أولًا. ليبيا لا تحتاج إلى مزيدٍ من الوسطاء، بل إلى ضميرٍ وطنيٍ جديد يُعيد تعريف معنى الانتماء، ويضع الكرامة الوطنية فوق حسابات النفط والولاء.
فحين تكون مصلحة الوطن معيار الحكم، وحين يكون العدل أساس التعايش، تتراجع الفوضى تلقائيًا، لأن جذورها دائمًا سياسية وأخلاقية قبل أن تكون أمنية.
إن ما يميز ليبيا، رغم كل هذا العناء، هو أنها لم تفقد بعد جذوة الأمل. فما زال في المدن الليبية من يكتب ويزرع ويبني رغم الخطر، وما زال في الشباب من يحلم بوطنٍ يستحق الحياة. ذلك هو الرأسمال الحقيقي الذي يجب أن يُصان.
فالأمم لا تنهض بالثروات وحدها، بل بالإيمان بقيمة الإنسان، وبالقدرة على تحويل الألم إلى طاقة. والمجتمعات لا تتجاوز جراحها إلا حين تمتلك شجاعة النظر إلى ذاتها دون خوف، لتقول بصدق: نعم أخطأنا، لكننا نستطيع أن نُصلح ما أفسدناه.
لذلك، فإن السؤال الحقيقي الذي يجب أن يطرحه كل ليبي على نفسه اليوم ليس: من المسؤول؟ بل: من يبدأ؟ من يملك شجاعة الخطوة الأولى نحو التغيير؟ لأن الإنقاذ لا يأتي من الخارج، ولا يولد من البيانات، بل يبدأ من إرادة داخلية تستعيد للدولة معناها، وللمواطن كرامته، وللوطن هيبته.
عندها فقط يمكن القول إن ليبيا قد خرجت من زمن الفوضى، ودخلت زمن الوعي. أما دون ذلك، فستبقى الأزمة دائرة في حلقةٍ مفرغة، تستهلك الأجيال كما استهلكت الأحلام، ويبقى الوطن معلقًا بين ماضٍ لم يُدفن ومستقبلٍ لم يولد بعد.
___________
![]()